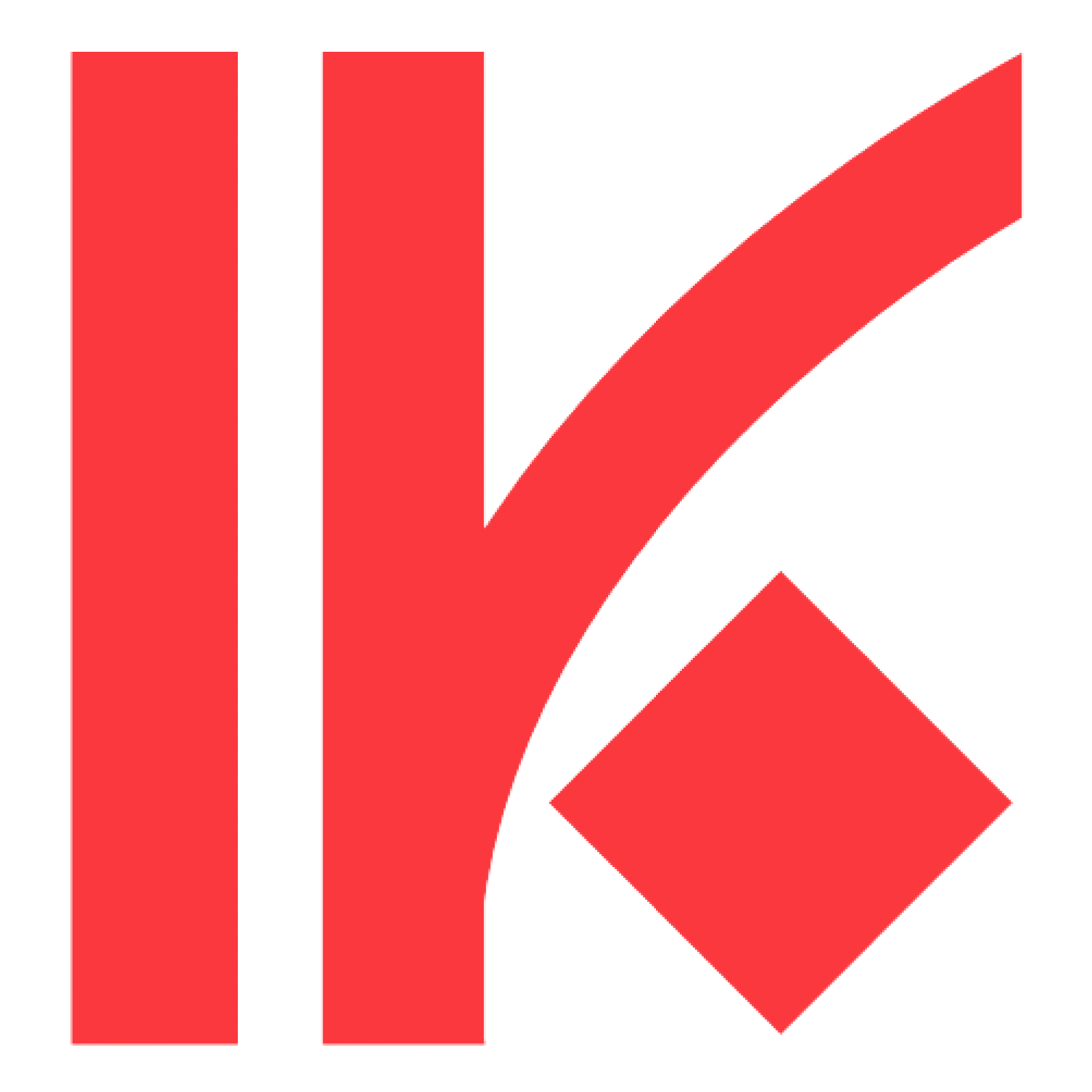نصّان لا يطلبان إذنًا للدخول.
الأول يخلع القناع عن وجه الهيبة، والثاني يسلخ جلد التبرير عن جسد الفشل.
لا صوت حيادي هنا، لا منطقة رمادية.
كل جملة صفعة، كل استعارة ركلة، كل سطر حفرة تُفتح تحت قدميك.
القراءة ليست استهلاكًا، إنها اختبار للقدرة على التحمّل.
من ينجو من الأول، سيُحرق في الثاني.
في هذا المستنقع الجغرافي ، لا أحد يعقم روحه؛ هم يدهنون خمجهم الداخلي بطبقات من “الطلاء اللفظي” ويُعلنون عنها اسم”هيبة زائفة”.
يبتسمون في وجه الجمود المميت كأنه “هبة إلهية”، يحيّونه بـ”تشنج عصبي في عضلات الوجه” المُدرّبة على الإخفاء.
يضحكون لها بأفواه محنّطة على الزيف.
كلّ ما يُمارس هو “فنّ الإفلاس الأخلاقي”:
الحزن “فعل إلزامي كاذب”، الولاء “مجرد ثقب أسود”، حتى الخوف صار يتأنق بملابس “التفاني المُطلق”.
يسيرون بمحاذاة الأنقاض، يعتبرونها لوحة فنية تجريدية، ويأكلون فتاتهم المتعفّنة بنكهة القبول المُلقى عليهم قسرًا كالقيء .
التاريخ ليس سردًا، إنه حفل تنكري لا ينتهي يقام أمام جمهور مبرمج على الانقياد.
كلما زكمت الأنوف من رائحة الفساد النتنة، أصدروا نشيدًا وطنياً جديدًا أكثر سخافة.
يتناقشون بحدة عن “الأمل المزعوم” مثل مجموعة من الغربان يتشاجرون حول جيفة في مقبرة مهجورة.
العدالة؟ مجرد “صورة فوتوغرافية” قديمة التُقطت في الماضي السحيق.
الكرامة؟ “وصفة علاج” تُباع في “صيدلية الخنوع”، تُمنح مجاناً لمن يُعلن ولاءه الكامل لـ”فكرة الركوع”.
أما الحقيقة، فهي “رجل كهل” يُعتقل يومياً بتهمة “التشرد الفكري”.
هذا وطن يتقن “تصنيع الأبطال الوهميين” أكثر من تصنيع الخبز، وطن يتنفس “أكاسيد التبرير” ويخرج بـ”ابتسامة واسعة” ليقول: “الموت هنا مجاني والمستقبل مُتخم بالوعود!”
والمواطن؟ يصفّق ببلاهة. لأنه فقد إحساسه بالجاذبية الأرضية، أو لأنه “دعامة” في بناء الوهم القائم، أو أنه مجرد “شاهد قبر” ينتظر دوره.
في ديرتنا يقال:
“هم حاطين حالهم عالصخام ومو طالع لهم غير الشحوار.”
يجلسون على الصخام، يتجادلون حول لون الشحوار.
يحسبون أن النقاش في السواد نوع من التقدّم، وأن تبادل اللوم نهضة فكرية.
يمرّ الوقت، يتبدّل كل شيء حولهم، وهم ثابتون كرمز للفشل المحنّط.
يتحدثون عن الأمل وكأنهم اخترعوه، وعن الغد وكأنه موظف يتأخر عن الدوام.
يعيشون على أنقاضهم، ويمنحونها أسماء جديدة: “خبرة”، “صبر”، “تجربة”.
كل سقوط عندهم شهادة نضج، وكل خيبة “درس قاسٍ من الحياة”.
أما الواقع أنهم لا يتعلّمون شيئًا، فقط يبرّرون سقوطهم القادم مسبقًا.
حين يحين موعد الحساب، يمدّون أيديهم لجني ثمار الانتظار الطويل.
يعودون محمّلين بالسواد، فيقنعون أنفسهم أنه علامة النضوج.
الشحوار يغطي الملامح، لا يخفيها، يفضحها أكثر. لكنه بالنسبة إليهم وسام شرف يثبت أنهم “مرّوا بالتجربة”.
الطريف أنهم ما زالوا ينتظرون الانفراج من نفس الزاوية التي احترقت.
ينتظرون شيئًا لم يأتِ منذ عقود، ولن يأتي، لأنهم لا يغادرون المكان الذي ابتلعهم .
وهنا السؤال الذي لا يجرؤ أحد على طرحه:
إلى أي حد يمكن للوجه أن يسوَدّ قبل أن يفهم صاحبه أن الضوء ليس عدوه؟
أم أن الصخام صار هويةً معترفًا بها… تُورَّث مع الفخر؟ —
من أين يبدأ التلوّث حين يصبح التنكّر عادة؟
هل يصدأ الوجه من فرط التجميل؟
أيّهما أخطر: القذارة المكشوفة أم تلك التي تُقدَّم كإنجاز؟
هل يحقّ للأنقاض أن تتكلّم؟
هل الشحوار يُمحى أم يُورَّث؟
من يكتب النشيد القادم حين تختنق الكلمات؟
وهل ينجو من لا يصفّق… أم يُدفن بصمت؟
ملحق:
الصخام (أو “السخام”): السواد الثقيل والمتماسك الناتج عن الحريق أو الاحتراق غير الكامل ، مثل سواد القدر (الإناء الذي يُطبخ فيه) ، والفحم أو الرماد الذي يلتصق بالأرض..
الشحوار: (أو “الشحار” في بعض اللهجات) خاصة في مدن مثل منبج وديرالزور (سوريا)، حيث يُقال “سچن” أو “شحوار” لفضلات المدفأة أو الرماد الخفيف الذي يتطاير. وأصله آرامي/سرياني تعني “السواد الداكن” أو “الرماد الأسود”..مثال تعبيري: “يا شحاري!” = تعبير مجازي عن الظلام أو المصيبة، كأن الوجه مغطى برماد حريق.
الفرق بينهما: “السخام/الصخام” أثقل وأكثر تماسكًا (كالفحم أو سواد القدر)، بينما “الشحوار” أخف ومتطايرًا (كالرماد الذي يلتصق بالجلد أو الوجه).




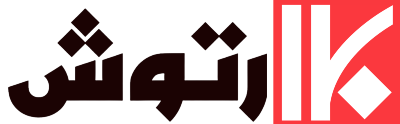
 ماهر حمصي
ماهر حمصي