
أن تقرأ كتابًا لشخص قريب من عمرك ومن مدينتك نفسها وتواصلت معه مسبقًا ولو لمرات قليلة، قد يكون أمرًا سخيفًا يجر كومة من المجاملات لا سيما أن موضوع الكتاب هو الرابط الأول بينكما (مدينة سراقب في الشمال السوري).
قد يتحول الأمر أيضًا إلى سجال بين رؤيتك ورؤيته للمكان والأحداث والشخصيات ولو بنحو خفي. وقد تغدو كل تلك الأسباب حاجزًا دون قراءة الكتاب أصلًا.
يمكن استغلال الأمر أيضًا لطرح أسئلة كثيرة، لا سيما أن الكتاب تظهر فيه الفترتين: العقود الستة (1950-2010)، والأعوام الستة (2011-2017) التي يسميها الراوي “آخر سبع سنين”.
بين كارثتين
كل شخص لديه موقف من الفترتين المذكورتين يشمل جميع تفاصيل الحياة، وقد وصل الأمر حد الرفض الجذري أو الحنين القاتل أو الندم.
إذا ولدتَ في جيل التسعينات، فقد ولدت في عيد الشر، وبدأت بممارسة الحياة مع أحداث 2011، ونشرت أول أعمالك في حرارة ذلك الفرن، لذا يسهل على أبناء هذا الجيل الرفض الجذري والقسوة الزائدة حد التشفي، ولكن العذابات التي استمرت كانت أقسى، ليجد أبناء هذا الجيل أنفسهم بلا ماضٍ ولا حاضر.
لكنه ليس العمل الأول للكاتب، فقد نشر مجموعة قصصية أخرى قبل سنوات (اعترافات المسخ)، وفازت بجائزة الشارقة 2017.
لعنة الذكريات
يمكن تجاهل فترة ما قبل 2011 ببساطة، أو رفضها رفضًا تامًا، أو نقدها وهو أمر شائع في الروايات والمسلسلات، ولكن حطاب الحكايات اختار النوستالجيا والحنين إلى البساطة والتراث واحتضان الذكريات والماضي، وأقصى ما يمكن أن يحققه هذا النوع سؤال: لماذا سُلب كل هذا منا؟ إنه موضوع مستهلك، لذا تعد الكتابة فيه تحديًا أيضًا.
تبقى صورة البلد في ذهن المغترب كما كانت في اللحظة التي غادرها فيها، ولكن محمد يتجنب تلك السنوات بالذات، فلا يذكر سنوات الجامعة ومغادرته البلاد وأسبابها سوى في نص واحد، بوصفها جزءًا من مخاوف الهاربين أو تجاربهم، وهو النص الوحيد في الكتاب الذي ينفرد بمواضيع الفترة الثانية، بينما تتجاور المرحلتين في نصوص أخرى.
هل هذه قصص؟
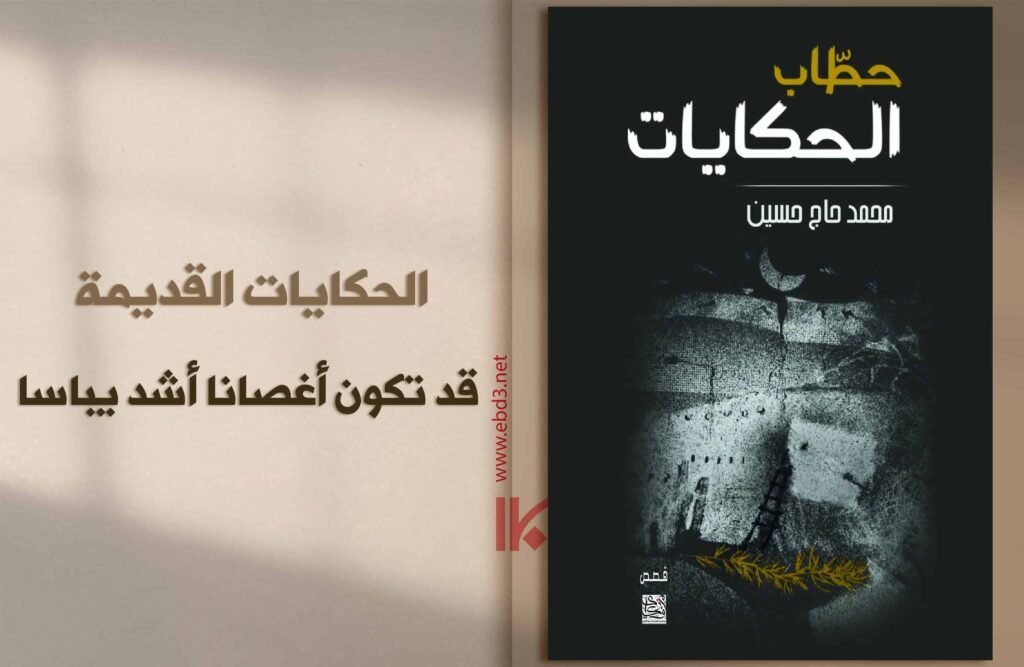
يمكن أن تبدأ الكتاب من أي نص أو أية فقرة، وتقفز إلى مكان آخر، وهكذا. “يُمكنك القول إنها استوت حتى تكاد تكون بلا ارتفاعات، هذه البقعة التي يسكنها اللون الأخضر، ويفصلها جسر حلب-دمشق، عن الأراضي والمدينة، التي تصمت في الشتاء، حيث تسكنها الريح، وسهرات الحكايات والأغاني”. (الكتاب ص21)
يهرب الكُتاب حاليًا من وضع كلمة قصة على نصوصهم، ولسنا بصدد استحضار تعريف للقصة، بل يهمنا أن نقدم هذا العمل الذي بين أيدينا، أو أن يقدم لنا هذا العمل شيئًا. إنه سرد يعتمد على الشعرية والتكثيف، مطعم بعشرات الحكايات التي تظهر كأغصان صغيرة جمعت بعناية: “أم أحمد كانت تسر لي كل قصص أمي وأبي وقصصها، والجميع، في سعادتها التي لم تتبدل روت لي كيف تعرفت بزوجها، كان جالسًا قرب “جدار المعلوسة” يلف السجائر، دنت منه وقالت:
لفلي سيكارة تتن من باكة الغازي
وإن جاد نارك طفت شعل من بزازي”. (الكتاب ص23)
في كتابات محمد الكثير من الشعرية والحكايات التي نقلها بأمانة، ولم يضف عليها وصفات خيالية رخيصة. لكن إذا كنا نصدقه في الحكايات التي رواها عن السنوات التي عايشها ورآها أو نعد هذا وجهة نظر الراوي، فإن ما يرويه عن السنوات القديمة السابقة لولادته شاحب جدًا، ولا يزيد عن كونه حكايات خضعت للتشذيب عشرات المرات من حطابين آخرين.
فعندما يتحدث مثلًا عن كرة القدم في المدينة والملعب وبطولة الكرة في المدرسة، لا يخجل من أن يقول إن فريقه كان يعتمد على لاعب ممتاز ولاعب موهوب فقط، وإن كلا اللاعبين قُتلا في قصف للمدنيين. أما الحكايات القديمة فقد تكون أغصانًا أشد يباسًا لكن ملامحها اختفت، ولك مطلق الحرية في أن تشعل فيها النار أو ترميها ببساطة.
ونختم بسؤالين: الأول أنقله كما سمعته، كما نقل لنا الكاتب حكاياته، قال أحد الأصدقاء: “عندما أراهم يكتبون عن مدينتي أحس أنهم يتحدثون عن مدينة أخرى”. والثاني: إذا افترضنا أن المكان أو المدينة كائن حي له شعريته، كيف يمكن التقاطها؟ إذن، إنها محاولة للتعبير عن المدينة وحياة شبابها، محاولة محكوم عليها بالفشل، وكما يقول بودلير: جميلة كحلمٍ من حجر.
(حطاب الحكايات – محمد حاج حسين – قصص – دار موزاييك 2021، عدد الصفحات: 102)




 ماهر حمصي
ماهر حمصي