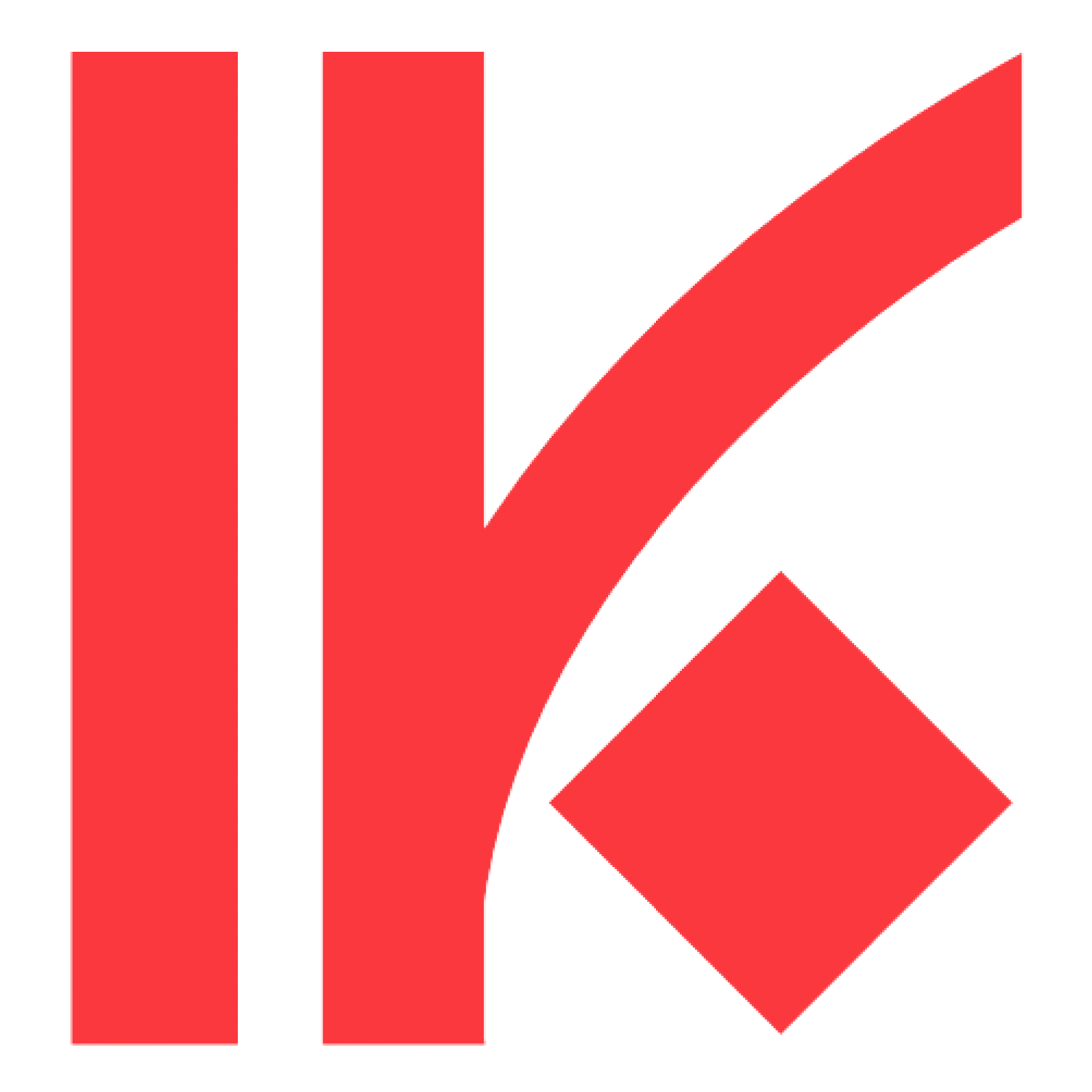هل جرّبت يوماً أن تتراجع قبل أن تبدأ؟ أن تُقنع نفسك بأن لا فائدة من المحاولة، لأن الماضي يخبرك أن كل الطرق تنتهي إلى الهزيمة؟
هذا الإحساس ليس ضعفاً في الشخصية، بل نتيجة عملية ذهنية خفية تُعرف بـ “العجز المُكتسَب” (Learned Helplessness)، وهي واحدة من أكثر الظواهر النفسية تأثيراً في طريقة تفكير الإنسان واستجابته للحياة.
حين يتعلم العقل الاستسلام
العجز المُكتسَب يعني ببساطة أن العقل البشري، عندما يتعرض مراراً لتجارب لا يستطيع السيطرة عليها، يتعلم أن الجهد لا يُحدث فرقاً.
ومع الوقت، يتحول هذا الاستنتاج المؤقت إلى قناعة مزمنة بأن الأفعال لا جدوى منها، حتى لو تبدّلت الظروف.
مؤسس النظرية، عالم النفس مارتن سليغمان، اكتشف هذه الظاهرة في تجاربه على الكلاب. كانت الكلاب تُعرض لصدمات كهربائية خفيفة لا يمكنها تجنّبها، فاستسلمت. لاحقاً، حتى عندما أصبحت قادرة على الهروب، ظلت ساكنة في مكانها.

الدرس الصادم؟
إن الدماغ — حين يتعلم العجز — يفضّل الألم المألوف على الأمل المجهول.
رحلة التعلم المعكوس: كيف يُبرمجنا الفشل؟
تحدث عملية “التعلّم المعكوس” هذه عبر ثلاث مراحل متتالية:
1. التعرض لعدم السيطرة:
تكرار الفشل، أو المرور بعلاقة سامة، أو بيئة عمل قاسية، أو حتى طفولة يغيب عنها الدعم والتشجيع.
2. التفسير الداخلي الشمولي:
يبدأ الفرد في إرجاع كل إخفاق إلى نفسه:
“أنا السبب، أنا لا أستحق النجاح، أنا محكوم عليّ بالفشل.”
3. فقدان الدافع والإحساس بالسيطرة:
وعندما تتاح له فرص جديدة، يتراجع تلقائياً، كأن ذاكرته تهمس: “لا تحاول، النتيجة محسومة سلفاً.”
الدماغ حين يتعلم الألم
دراسات علم الأعصاب تؤكد أن العجز ليس فكرة فحسب، بل توصيلة عصبية تتكرّس داخل الدماغ.
فمع كل تجربة فشل، يعيد الدماغ برمجة دوائر المكافأة والتحفيز، فيرتبط الجهد بالألم لا بالإنجاز. ومع الزمن، يصبح الكسل الذهني آلية دفاع: طريقة لتجنّب الإحباط القادم قبل أن يقع.
لكنّ المدهش أن الدماغ نفسه الذي تعلّم العجز، يمكنه أن يعيد التعلم بفضل ما يُعرف بـ اللدونة العصبية (Neuroplasticity) — وهي قدرة الخلايا العصبية على بناء وصلات جديدة عند التعرض لتجارب محفزة. أي أن الشفاء ممكن بالتكرار العكسي: تجارب نجاح صغيرة تبرمج العقل من جديد.
العجز المُكتسَب في الطفولة: حين يغرس الخوف جذوره مبكراً
كثير من جذور هذا العجز تتكون في الطفولة، حين يتلقى الطفل رسائل خفية تُضعف ثقته بنفسه:
“اترك، أنت لا تعرف.”
“دعني أنا أفعلها عنك.”
“أنت دائماً تُخطئ.”
بهذه العبارات البسيطة، يتعلم الطفل أن محاولاته بلا قيمة، وأن الأفضل هو التراجع. ومع الزمن، تتحول تلك الرسائل إلى صوت داخلي يرافقه طيلة حياته:
“لماذا أحاول إن كنت سأفشل؟”
في الحياة اليومية: الأقفاص غير المرئية
العجز المُكتسَب لا يظهر في المختبر فقط، بل يتسلل إلى تفاصيلنا اليومية:
في العلاقات:
من تعرّض للخذلان أكثر من مرة، يُقنع نفسه بأنه غير محبوب، فيغلق أبوابه طوعاً.
في الصحة:
من فشل مراراً في إنقاص وزنه، يختبئ خلف مقولة “الأيض عندي بطيء”، ويكفّ عن المحاولة.
في الإبداع والعمل:
من سُخر من أفكاره في بيئة عمله السابقة، يصمت في الاجتماعات الجديدة، حتى لو تغيّر المناخ من حوله.
تلك ليست أمثلة على الكسل أو التشاؤم، بل على برمجة عصبية عميقة ترى في الأمل خطراً لا مكافأة.
من العجز إلى الفعل: كيف نُعيد تدريب العقل؟
الخبر السار أن هذا الوهم قابل للتفكيك. فالعجز ليس قدراً، بل عادة فكرية يمكن قلبها بالتدريب الواعي:
1. تبنّي “عقلية النمو” (The Growth Mindset):
طوّرتها عالمة النفس كارول دويك، وتقوم على فكرة أن القدرات ليست صفات ثابتة، بل مهارات قابلة للتطور.
استبدل جملة “أنا لست جيداً في هذا” بـ “أنا لست جيداً بعد.”
الفشل هنا ليس وصمة، بل مرحلة تعلم.
2. النجاحات الصغيرة:
لا تبدأ بمعركة ضخمة.
اختر هدفاً صغيراً، قابلاً للتحقق بنسبة شبه مؤكدة.
قراءة عشر صفحات، الخروج للمشي، ترتيب مساحة عملك.
هذه الإنجازات البسيطة تُرسل إلى الدماغ إشارات بأن الأفعال تُحدث فرقاً، فتبدأ شبكات الأمل بالاستيقاظ من سباتها.
3. إعادة الإسناد (Re-attribution):
عندما تفشل، لا تُصدر حكماً نهائياً على نفسك، بل اسأل:
ما الجزء الذي كان تحت سيطرتي؟
وما الذي لم يكن كذلك؟
حينها يتحول الفشل من لعنة إلى معلومة، ومن وصمة إلى دليل تحسين.
حين تستعيد ذاكرتك قوتها
إن التحرر من وهم العجز لا يعني تجاهل الفشل، بل إعادة تفسيره. أن تدرك أن التجارب الماضية لم تكن نبوءة، بل تدريباً على الصمود.
كل محاولة صغيرة هي تمرين على استعادة السيطرة، وكل نجاح بسيط هو إعادة توصيل لأسلاك الإرادة.
الدماغ لا ينسى الفشل، لكنه قادر أن يتعلم الشجاعة من جديد. وما كان يوماً جداراً يمنعك من الحركة، قد يتحول لاحقاً إلى جسر تعبر عليه بثقة نحو ذاتك الحقيقية




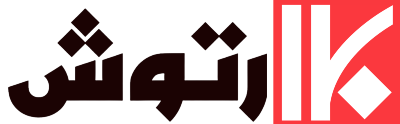
 ماهر حمصي
ماهر حمصي