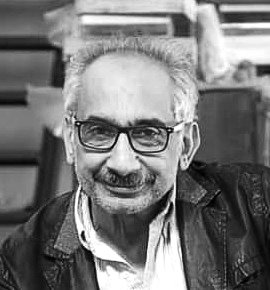
إذا سألتني، ماذا حدث لي في سنة /1968/؟ فسأجيبك بعد قدر لا بأس به من الوقت أحاول به أن أتذكر: “لا شيء!”. وكأن هذه السنة ليست إحدى سنوات حياتي. إذا تابعت وسألتني، ماذا حدث لي في هذا العقد أو ذاك العقد من السنين؟
فسأقول لك، صدقًا لا أذكر شيئًا. ما عدا بضعة أحداث لا تستغرق مني روايتها أكثر من ثلاثة أسطر! /1973/ كنت على الجبهة وخضت الحرب، /1978/ سافرت إلى بولونيا وماتت أمي في غيابي، /1979/ صدر (بشر وتواريخ وأمكنة) /1981/ تزوجت! لا تزوجت سنة /1980/، /1981/ ولد ابني الأول. /1997/ صدرت مختاراتي (مزهرية على هيئة قبضة يد). /2004/ صدرت مجموعتي (الشاي ليس بطيئًا). أستطيع أن أذكر تواريخ إصدار أي مجموعة من مجموعاتي قبل /2011/. أما في /2011/ فقد حدث ما لن أنساه وما أنساني بدوره كل شيء! ولولا هذا الذي، بدافع غامض كأنه الرغبة الكامنة في كل حي لنقل جيناته الوراثية، كتبته في يومياتي، لكان كل شيء في عهدة النسيان.. قليل الذمة!
أما إذا سألتني، ماذا يهمك أنت كقارئ من قراءة مذكراتي؟ فأرجوك، لمجرد السؤال، أن تتوقف عن قراءة هذا الذي أمامك منذ هذه اللحظة! وتستدير للقيام بأمور أكثر عملية، أكثر نفعًا، فهناك ما لا يقل من ألف عمل نافع أكثر من قراءة مذكرات شخص ما. فما بالك بشخص، كشخصي، يكاد أن يكون معدوم الأهمية على المستوى العام! وكما يقول ميشيل دي مونتاني 1933-1592، في مقدمته الصغيرة لكتابه (المقالات) الذي يبلغ عدد صفحاته في الطبعة العربية /1750/ صفحة: “إني أنا نفسي مادة كتابي أيها القارئ، وليس من المعقول أن تشغل وقت فراغك بموضوع تافه كهذا”! بعدها تم تصنيف هذا الذي يقول عنه صاحبه: “موضوع تافه” ضمن قائمة الـمائة كتاب الأشد تأثيرًا في الجنس البشري. وكأنه يجب عليّ الآن أن أستدرك، وأقول، إني بالتأكيد لا أضع نفسي ولا أضع كتاباتي في مستوى مونتاني ومقالاته التي قال عنها نيتشه إنها زادت بهجة العيش في هذا العالم! أو جان جاك روسو وأحلام يقظته وهو يتجول وحيدًا، التي كتبها قبيل وفاته على أن لا يقرأها أحد! فكل ما أطمع به، يا من ما يزال يتابع القراءة حتى هنا، لا يزيد عن محاولتي سرد أحداث لو لم تحدث لما تغير شيئًا في العالم، مرفقة ببعض الأفكار البسيطة وربما الساذجة، عني وعمن حولي!، أولئك الذين لولاهم لما كان هناك معنى لأي شيء! لأنه كما الوقت لا يتحقق إلّا بالتبدلات والتغيرات، فإن الفرد لا يتحقق إلّا بالآخر، سلبًا أو إيجابًا. عسى أن تجد في كل هذا الهذر قدرًا ما من المتعة، ولو المغشوشة كما كل المتع!
———–
3/1:
– الأربعاء، اليوم الثالث من السنة الجديدة، لا شيء جديد، كل شيء بقي في محله، لا شيء غيّر مكانه قيد أنملة. يا لها من خدعة.
– ربما كانت سنة /1967/، المنصرمة دون أسف، التي حلت فيها بنا تلك الهزيمة النكراء للأنظمة القائمة في الوطن العربي، وليس هزيمة للشعب العربي! هذا ما قلته منذ أيام في محاضرة للكاتب وليد إخلاصي عن هزيمة /5/ حزيران، وذلك لسبب جوهري هو أن الشعب لم يشارك بها! أهم سنة في حياتي لليوم، فقد اخترت، دون مشورة أحد، دراسة العلوم الاقتصادية في جامعة حلب. أول خيار في حياتي، وما أرجو ألّا يكون أسوأ خيار في حياتي.
10/1:
– الشمس لا تذيب الثلج، بل بالعكس تجعله جليدًا قاسيًا.
– علّق سائق باص النقل العام الذي يصل السكن الجامعي بالمدينة، وهو ينظر إلى بعض الفتيات الجامعيات يتقاذفن بكرات الثلج: “من شدة حماوتهن يلعبن بالثلج”!
12/1:
– يقوم مدير المدينة الجامعية بدوريات تفتيشية على الغرف لمصادرة السخانات الكهربائية. راغب مشلوط الحمصي رفض تسليم سخانته بحجة أنه من دونها يمكن أن يموت من البرد، وعندما أصرّ المدير على أخذها، قام راغب ورماها من الشرفة! وهات يا ضحك.
7/2:
– حلمت البارحة بأني لست أنا، بل أخو أنا، أي أخو منذر، ولكن ليس ماهر أو رفعت الصغير، بل أخ آخر لا أعرفه، وبأني قادم لزيارته في غرفته في المدينة الجامعية لتسليمه غرضًا ما!
– كأن النضوج يتجلّى في القدرة على رسم الأقنعة.
– أتأمل المناظر الطبيعية على دفتر مذكراتي ذي الورق اللماع الذي أحضره لي أبي من سويسرا، جميلة، جميلة جدًا.. فأكتب: “لكنها لا تعني لي شيئًا، ليست وطني”.
4/3:
– محاضرة وزير الخارجية السورية ابراهيم ماخوس، في قاعة كلية العلوم الاقتصادية: “نأمل منكم الكثير، ونحن بانتظار تخرجكم لتقودوا الاقتصاد السوري الاشتراكي”. من أنا لأصدق كلامًا كهذا؟
– تعطّلت منذ برهة ساعتي، لذا لا أعرف بدقة عمري.
21/3:
– رفاقي وجيراني في المدينة الجامعية في حلب، المغربيان عبد اللطيف عواد ومحمّد العلج، والسوداني عمر عبد السلام، والفلسطيني نعمان كنفاني أخو غسان كنفاني. أما السوريون، فأقربهم إلي بسام جبيلي من حمص، وهؤلاء جميعهم يدرسون معي في كلية العلوم الاقتصادية، أما محمّد رعدون الذي يدرس الأدب العربي، فهو من قرية قريبة من مدينة آفاميا الأثرية الواقعة في محافظة حماه! وعهد إسماعيل من اللاذقية يدرس زراعة، وآخرون من المدن السورية كافة، ما عدا حلب طبعًا. نحيا معًا وكأننا في ثكنة.
25/3:
– دعانا نعمان كنفاني للاحتفال بانتصار المقاومة في معركة الكرامة منذ ثلاثة أيام على الحدود الأردنية! ولم أكن على دراية بها ولا بأي من تفاصيلها على الإطلاق! كان سعيدًا كما لم أره من قبل! ذلك أن وجهه باصفراره الدائم وبملامحه المتطاولة، كان يوحي لي أنه لا يمكن أن يكون سعيدًا في يوم من الأيام!
2/4:
– عزام قطرنجي، من حماه، تتشارك غرفتانا في الطابق الثاني الجهة الشرقية شرفة واحدة. في غيابي يدخل غرفتي من باب الشرفة غير المجهز بقفل ويرتدي من ثيابي!
– البارحة عزام قطرنجي، يخرج من الحمام المشترك في الطابق الرابع عاريًا، ويصيح بكل من يهرب من أمامه في الممر ويطبق بوجهه باب غرفته: “إذا كنتم تخافون من هذا، فكيف سوف تحاربون الاسرائيليين”.
5/4:
– بسام جبيلي يعود من المدينة حاملًا حذاء جديدًا ابتاعه من محل (ريد شو) في سوق التلل، حذاء بني ببوز عريض ونعل سميك وكعب ضخم، يصعد الدرج بانفعال وهو يقول: “إنه الحذاء الذي حلمت به طوال حياتي”.
– بشار مفتي، شاب لاذقاني يدرس الهندسة، يقول لي، إنه متأكد من وجود فوارق بيولوجية بين البيض والسود، فالعرقان ليسا بذات المستوى من التطور البيلوجي! وأنه يومًا سيكتشف العلماء هذا وسيعلنونه! أرد عليه بأن هذا تبرير مرفوض للتفرقة العنصرية.
– يطابق أكثر الناس الذين عرفت في اللاذقية وحلب، ولو بدون قصد، بين البشر الغامقي البشرة (السود) وبين العبيد. ليس لدينا أي ثقافة في مجال التفرقة العنصرية.
25/4:
– كعادتي أرجئ الدراسة حتى أيام الامتحانات، فأقوم بدارسة كل مادة قبل موعد امتحانها! المشكلة إذا كان هناك أكثر من مادة في يوم واحد!
– خلال أيام الفحص أتلهى بقراءة مكسيم غوركي (فرنكا أوليسوفا) تعريب، هكذا كتب، حنا مينة.
30/4:
– أحد ما، شيء ما، يجبرني على كتابة هذه السطور كل يوم.
– ترى ماذا يتكلم المتكلم عندما يتكلم أمام نفسه الصامتة، أمام من لا يتكلم، ولا يبدي رفضًا أو موافقة. ولكن مهلًا، كيف أعلم أنها ليست هي من يتكلّم الآن، ليست هي من تملي وأنا أكتب؟
– كلماتي ثياب نفسي وأصباغها.
5/5:
– أهدتني زوجة قبطان الباخرة الهندية اسطوانة /45/ دورة، لفرانك سيناترا يغني (Strangers in the night) من يصدق!
27/5:
– بلغت التاسعة عشرة، أكتب رسائل إلى أمي “أحب الحياة فكيف لا أحب من وهبني إياها”. وأيضًا إلى أبي وأخي ماهر ولا أرسلها، وكأنني أكتبها فقط لنفسي.. يا للأنانية.
– اليوم سابدأ من جديد حياة جديدة.. منذر جديد.
19/6:
– في دمشق، أبتاع من محل شاهين للموسيقى، مقابل جسر فيكتوريا، ألبوم لفرقة رولينغ ستونز (Satanic Majesties Request- 1967)، بمبلغ /20/ ليرة سورية، أسال البائع لماذا هو أغلى من بقية الألبومات بـ /4/ ليرات، يقول لي، خذه بلا غلاف بـ /16/ ليرة! أمضي نصف ليلتي في أحد فنادق ساحة المرجة أتأمل غلافه الساحر، حيث ألصقت صورة بلاستيكية لأعضاء الفرقة بثياب مزركشة، تتبدل وضعياتهم عندما تنظر إليها من زاوية مختلفة!
25/6:
– أبي ومرام ومنى، جاؤوا إلى حلب مصطحبين معهم السيدة الهندية السمراء اللطيفة وهي ترتدي ساريها الأزرق الشفاف، زرنا معها المتحف والحديقة العامة.
– أخبرني أبي بأنهم لم يدعوها تدخل مسجد أمية في دمشق قبل أن تغطي الجزء الأوسط من جسمها. وأنها قبلت بهذا دون أن تبدي أي انزعاج.
1/7:
– ترفعت للسنة الثانية، قانون الترفيع في كلية العلوم الاقتصادية، لحسن حظي، لا يتطلب النجاح في كل المواد. تظهر النتائج أنه لدي مادتان تحت معدل النجاح. وباقي المواد فوق المعدل بقليل.
15/7:
– أيام صيفية، تصعد العائلة جميعها إلى شاليه خالي خالد في الشاطئ الأزرق. يأتي معنا مصطفى دائمًا.
– رحلة مع أولاد الحارة، ممتاز ومالك وعمر على البسيكليتات إلى جبلة. لدي هناك صديق تعرفت عليه يومًا في نادي توجيه الناشئة، يسكن بيتًا كبيرًا يشبه القصر! مولع بالمطربة صباح!

3/9:
– بالتأكيد، بالنسبة لي، شيء أقرب للنعمة، هنا في سوريا، في حلب، في مدينتها الجامعية الكئيبة الأشبه بسجن منعزل على طرف المدينة، أني أستطيع الاستماع إلى إذاعة (BBC) بالإنكليزية. يقول المذيع الآن إن ألبوم البيتلز الأبيض، قد جعل الحياة في بريطانيا أفضل. نعم البيتلز جعلوا حياتي أنا أفضل بالتأكيد!
14/9:
– أقرأ رباعيات عمر الخيام. وأشعر بنفسي كمن يسبح في نهره، فيحملني إلى مصبه البعيد.
– علمني بسام دروبي، أن أربط رأسي بالمنشفة بعد الحمام، وذلك للحفاظ على تسريحة الشعر! كما علمني وضع البنطال تحت الفراش، للحفاظ على الكوية.
15/9:
– اضطررت لأن أبدأ أول يوم في السنة الثانية من دراستي العلوم الاقتصادية في جامعة حلب بقتل صرصار! وكأنه كان ينتظر خارجًا عند الباب، بحيث أني عندما فتحت الباب دخل مسرعًا باتجاه أسفل السرير! فكان لا بد!
20/9:
– حضرت وحدي، كالعادة، فيلم (باراباس) تمثيل أنتوني كوين! اللص وقاطع الطريق الذي عفى عنه اليهود بدل المسيح، لكنه في النهاية صار مسيحيًا ومات شهيدًا! لم يكن هناك في صالة سينما روكسي، عرض الساعة الرابعة بعد الظهر، سوى أربعة مشاهدين أنا واحد منهم!
28/9:
– يقول لنا الدكتور خالد صيداوي، ابن مدينتي، خريج ألمانيا الشرقية، وهو يشرع سيجارة المارلبورو بين أصبعيه: “إذا لم تتح الاشتراكية لي، ولسواي، تدخين المارلبورو، فبئس الاشتراكية”.
12/10:
– لا أظنني أصلح أن أكون شاعرًا، يومًا لم أهتم بالشعر، ولغتي العربية دون الوسط، ولكني سأجرب. الحقيقة لا يعجبني هذا الشعر الذي أسمعه على مدرجات الجامعة. أقارنه بكلمات أغاني البيتلز وكات ستيفنز وبوب ديلان وغيرهم، فأجد فارقًا كبيرًا .
– أعجبني من أقوال النفري أكثر من أي شيء، قوله: “كلّ ذي عدة مهزوم” أجده يناسبني لأنه ليس لدي أي عدة شعرية.
– كتبت قصيدة ومزقتها، عنوانها: “أين يذهب الوقت؟”.
11/11:
– وجدوا يدًا بشرية بثلاثة أصابع في الأرض التي تغطيها الأعشاب البرية في الجهة الخلفية لوحدة السكن الجامعي الأولى. تبين لاحقًا أن أحد طلاب الطب قد رماها من شرفته. ليس بالأمر العادي أن تدوس بحذائك كتلة ما، تنظر لترى ما هي، فإذ بها يد إنسان مشلوحة على الأرض! قامت المدينة الجامعية كلها وما قعدت. وكأنه متفق عند الجميع أن أجزاء الجنس البشري مقدسة.
2/12/1968:
– أنهيت قراءة مسرحية توفيق الحكيم (نهر الجنون). أحببتها، وكأن الحكيم من الذين يستحقون أن يحرص المثقف العربي على قراءة كل أعمالهم! قرأتها في يوم واحد.






 ماهر حمصي
ماهر حمصي