
أن يوقعك الحظ العاثر، فتولد في هذه الجغرافيا، وفي هذه الحقبة بالذات، فهذا يعني أنك تحتاج لأحلام اليقظة ولأحلام النوم أيضاً، لترمّم وترفو رقع حياتك المتلاصقة على نحوٍ فوضوي وغير متسق. أحلام؟ أجل. فحين تشعر أن كامل المحيط ممسوك بقوة وإحكام، بحيث أن قوىً ما (حاضرة دائماً) سوف تقوم بتدمير أي فعل واقعي للتغيير نحو ما هو أفضل، سوف تصل إلى هذه الخلاصة البائسة، وتهرب نحو الأحلام.
لسهولة إيضاح فكرتي سأعود للسجن. السجن مكانٌ ممسوك بإحكام من قبل العسكر والجلادين، ولا يختلف كثيراً عن الحياة التي نحياها اليوم، إلا في بعض التفاصيل، لجهة أن السجن حالة كثيفة من الضبط. في سجن صيدنايا كان حلم النوم، الذي راود معظمنا (أعتقد جميعنا)، والذي يمكن وصفه بالحلم المشترك، هو الخروج من السجن في إجازة تُمنح لنا لأيام. حلم عام مرَّ في ليالي معظم السجناء ولم يختلف فيه شيء بين سجين وآخر، إلا لجهة مفردات شخوصه، وأبطال الاشتياق الذين يخصّون كل فرد منّا. من ناحية أخرى، وكفعل إرادي، كنا نبتكر حلولاً علاجيةً أكثر شططاً في أحلام اليقظة، لمقاومة بلادة الحياة اليومية الرتيبة والليالي الطويلة.
في السجن، كما في الواقع السوري القاسي والمتصلّب اليوم، تزداد القناعة أنه لا مكان حتى للتفكير بالفرار، ولا بتغيير شروط العيش، ولذا كنا ندفع الأيام بحلم الحرية التي سوف تأتي يوماً ما، إضافة إلى بعض اختراعات الجمال، ما يخفف من سواد المشهد. منذ لحظة الاعتقال الأولى، يصبح الضحية بلا أية إمكانية للفعل، وهو دائماً محكوم بما يريده السجّان الغريب، من حيث المكان والزمان. والغريب هنا ليست صفة محايدة، بل محايثة لكل فعل يصدر عنه. والضحية هنا إما السجين، أو أي سوري وُلدَ في هذه الحقبة.
كانوا يجرجرونني على درج البناء، عندما استطعت بصوت متقطع أن أطلب من زوجتي أن تحصل لي على إجازة من العمل لمدة ثلاثة أيام. وقد اعتبرتُها مدةً كافيةً للنقاهة. فبعد تحقيق مرهقٍ قد يدوم عدة ساعات، وبعد تلف الأعصاب، يحتاج الإنسان إلى يومين من الراحة قبل العودة لمزاولة العمل. حشدُ الجنود لم يكن يدعو لطمأنينة كهذه، فقد استيقظت من نومي، لأجد جنوداً بكامل عتاد المعركة منتشرين في البيت وحديقة البناء، وعلى الدرج. خوذٌ ورشاشات ووجوه تقطر لؤماً وعداوة.
للوهلة الأولى، يتبادر للذهن، أن إنزالاً خارجياً معادياً قد احتلَّ المدينة ومن ضمنها، بطبيعة الحال، المنزل الشخصي. بعضهم كان يرتدي الثياب المدنية، “إنهم العملاء ولا شك” ستقول لنفسك. كل الجيوش الغازية، لا بد أن يكون لديها بعض العملاء في البلد المحتَل، والذين يقومون، في مثل هذه الحالة، بدور الأدِلّاء. عندما سمعتهم، وأنا أغالب النعاس، يتحدثون باللغة العربية. دخلت الطمأنينة الوطنية إلى قلبي، ومع ذلك ازداد وجيبهُ. فأفراد جيش الاحتلال، حتى لو أتقنوا لغتنا، فإنهم بالتأكيد، لن يتقنوا هذه اللهجة المغرقة في المحلِّية، والتي لا يمكن أن أخطئها أبداً.
يمكنني التأكيد اليوم، أنه في تلك اللحظة بالذات بدأ المنعطف الأهم في حياتي. هل بدت لكم كلمة “منعطف” مبتذلة كعادتها؟ ربما، لكنها الكلمة المناسبة تماماً هنا، لو أخذنا بالحسبان القوة النابذة التي تخلخل توازن الجسم في المنعطفات، خاصة لو كنَّا نركب حافلةً مسرعةً سائقها أرعن. في تلك اللحظة تغيرت علاقتي بالحلم، بل وتغير تعريفي للأحلام. وفي كل حياتي التالية لتلك اللحظة، كنت أحلم كما أفعل اليوم تماماً، وكما تفعلون جميعاً في السنوات الأخيرة على ما أخمِّن. مع سؤال دائم التكرار: هل كان ما حدث انعطافةً محكمةً حقاً، أم مكيدة حياة كاملة؟
يا لهول عدد المرات التي أعدت فيها ترتيب ما جرى. للمفارقة وغرابة المقارنة، يطيب لي أحياناً افتراض العمر مصاغاً ذهبياً قابلاً لإعادة التشكيل بصورة أخرى. لو أن هذا الخيط المتعرج مرَّ من هنا. ربما كان على تلك الانحناءة أن تكون أكثر حنوَّاً. لو أن ذاك كان قوساً بدلاً من تلك الزاوية الحادة المتجهمة. ماذا لو كان هناك نقش وردة فوق تلك المساحة المُصمتة. يا الله. أما كانت تلك التعديلات لتعطي هذا العقد، الذي يفتقد اللمسة المبدعة، حركةً تبعث شيئاً من الروعة أو، لو تواضعت الأحلام والأمنيات، شيئاً من الحياة.
هكذا قضيت العمر “هلكاناً” وحالماً. أُعدِّل ما خربت الحياة من أمنيات، عبثَتْ مخيلتي في كل ما حدث لي، واستبدلَته قسراً بمشاهد أحلى. رحتُ، بما يدفع للجنون، أبني ما يلبي نداءات الروح. تلك حديقة رغم صلافة الجدران وقضبان النافذة، وأنا سيّد ما أريد في دُوار ذاك الجنون. وفي ذاك الجنون أشبعتُ، بمحض الوهم، ما كانت تئن به عروق القلب، وأغلقت المنافذ كي لا يمر الواقعي المرير. يا الله، كم كانت حياتي المجموع الحسابي لخياراتي الخاطئة أحياناً، ومعطيات الجغرافيا غالباً.
لو كانت حياتي مقسمة إلى غرفٍ، لكانت غرفة الأحلام المكسورة هي الأكثر اتساعاً والأشد ازدحاماً، ففيها تقبع بقايا الهياكل العظمية لما كان يفترض بأنها مفردات الحياة الجميلة التي كنت أخمّن أنني سوف أحياها، ولو تواضعتُ قليلاً لقلت إنها بقايا عظام الحياة الطبيعية التي يعيشها باقي البشر على هذا الكوكب، وأكتفي أنا، ومثلي أنتم، أن أحلم بها.
إضافة إلى قتلهِ روح الإبداع لدى الناس، يحاول “الضبطُ” في بلاد الاستبداد، أن يتسرب حتى إلى لأحلام. أنا لحسن الحظ نجوت بأحلامي، ولذا فإن شطط الأحلام لدي يصل إلى حدود منفلته، منفلتة للدرجة التي تجعلني لا أرغب في التحدث عنها. والحلم كذبة بريئة (أحياناً تكون خبيثة) تُدلي بدفئها وسط صقيعِ واقعٍ بارد وكسيح، حيث الصدأ يعلو القلب والكلام والمفاصل. وإلى ذلك هو لا يحتاج للكثير من التعب، إنما فقط لبعض المخيلة القادرة على اختراع أشياء غير موجودة بالواقع، ولذا ما زلت، رغم كل ما جرى، أستخدم مخيلتي وأحلم بالحياة. وفي حالات من النشوة واشتعال الحلم، أخترع وطناً بلا ديكتاتور اسمه سوريا.
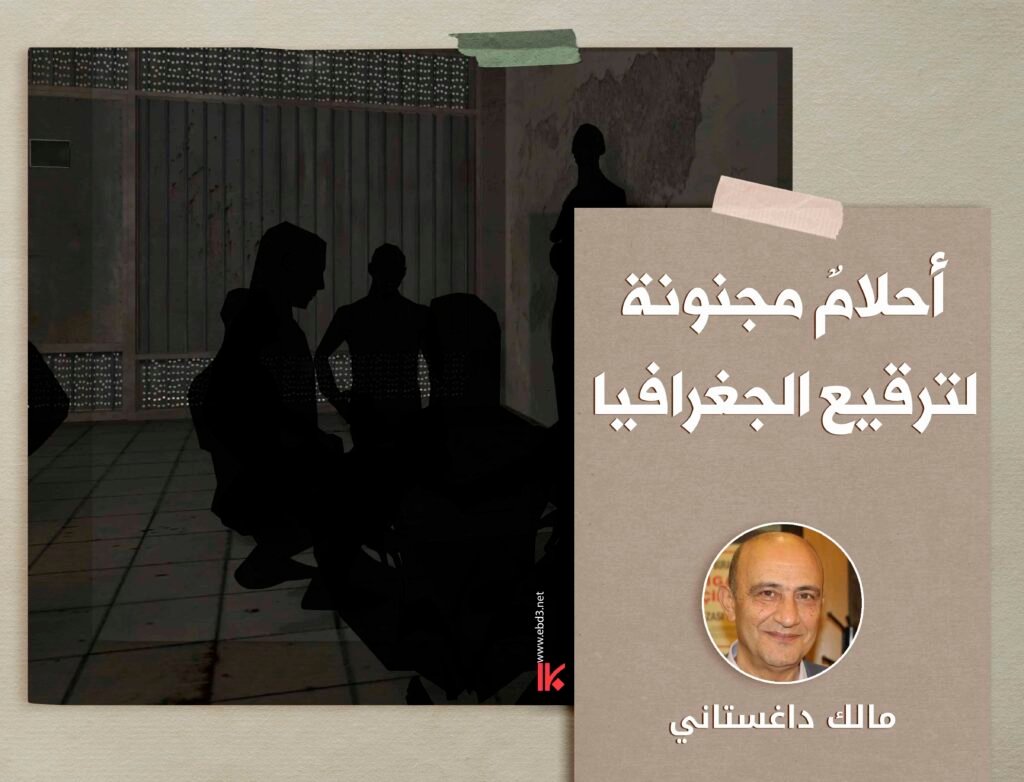




 ماهر حمصي
ماهر حمصي